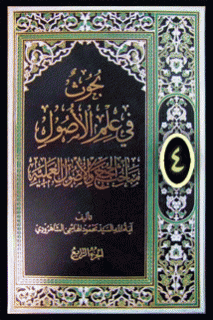فلم يلزم من حجيتها عدم حجيتها بل من حجيتها واقعاً التعبد بعدم حجيتها ظاهراً وهذا ليس بمحال وإِنْ كان لغواً إِذ لا معنى لجعل حجية تستلزم نفيها ظاهراً ، إذ يستحيل أَنْ تصل مثل هذه الحجية.
الثاني ـ ما يقتضيه النّظر الدّقيق في فهم الآية الكريمة وهي قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (١) ، فلقد قسمت فيها الآيات القرآنية إلى قسمين محكمات ومتشابهات ثمّ عابت على أهل الزيغ والهوى من اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتأويل وقد استفيد منه النهي عن اتباع المتشابه حيث اعتبرت ذلك طريقة أهل الزيغ وإِلاّ فلا نهي صريح عن اتباع المتشابه ، ولكن من الواضح انَّ المتفاهم عرفاً من هذا التعبير بعد تلك القسمة الثنائية انَّ النّظر إلى الذين يختصمون باتباع المتشابهات ويلتقطونها ويفصلونها عن المحكمات ابتغاء الفتنة والمشاغبة وتشويش الأذهان من خلال ذلك التشابه كما هو شأن من يريدون الفتنة والمشاغبة ، فظاهر الآية على هذا النهي عن مثل هذه الفتنة التي تكون بالاقتصار على المتشابهات والتركيز عليها من دون الرجوع إلى المحكمات التي هنَّ أُمّ الكتاب.
وقد ورد في تفسير الآية انَّها نزلت في نصارى آل نجران الذين كانوا يشنعون على المسلمين ببعض المتشابهات الواردة في حقّ عيسى وانَّ له حالة فوق البشر وانَّه روح منه سبحانه بغرض الفتنة والوصول إلى ما يزعمونه إِفكاً وكفراً ، وأين هذا من حجيّة الظواهر القرآنية بعد مراجعة المحكمات لغرض اقتناص المراد منها.
الثالث ـ ما ذكره المحقّقون من علماء الأُصول من المنع عن شمول المتشابه للظاهر ، فانَّ مجرَّد قابلية اللفظ لأنْ يستعمل في كلّ من المعنيين لا يجعله متشابهاً إِذا كان واضحاً بيّناً في أحدهما لكونه المعنى الحقيقي دون الآخر بل لا بدَّ من تساوي نسبة دلالة اللفظ إلى كلّ منهما وتقاربهما ليصدق عليه المتشابه وهذا لا يكون إِلاّ في المجمل.
وهذا الكلام لا ينبغي الشك فيه ، إِلاّ انَّ هناك بحثاً ينبغي استيعابه ، وهو انَ
__________________
(١) سورة آل عمران ، آية ٦.