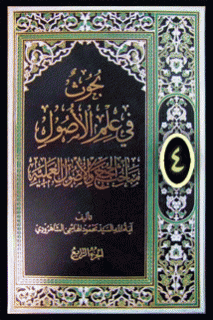إلا اختلافا في نفس الحكم العقلي العملي لا في صغراه.
والصحيح ـ في الجواب الحلي أن يقال : بان مدركات العقل العملي لا خلاف فيها في نفسها أعني فيما يدركه العقل بنحو الاقتضاء انه لا ينبغي أو ينبغي ، فالكذب مثلا لو لوحظ في نفسه يحكم العقل بأنه يقتضي أن لا يرتكب والصدق فيه اقتضاء أن يكون هو الصادر من الإنسان ولكن قد يقع التزاحم بين هذه المقتضيات كما إذا لزم من عدم الكذب الخيانة مثلا فيتزاحم اقتضاء الصدق للحسن مع اقتضاء الخيانة للقبح. وفي هذه المرحلة قد يقع اختلاف بين العقلاء في الترجيح وتقييم أحد الاقتضاءين في قبال الاخر فتشخيص موازين التقييم والتقديم في موارد التزاحم هو الّذي قد يكون غائما يشوبه الشك أو الخطأ ولا يكون بديهيا أوليا بل ثانويا ، ولا نقصد بالثانوي هنا كونه مستنتجا بالبرهان بل كونه مشوبا بالشك وعدم الوضوح ، وقد ذكرنا فيما سبق انه قد تكون معرفة غير برهانية وغير مستنتجة أي أولية ومع ذلك لا يكون واضحا بل يكون غائما ، وعليه فالاختلاف بين العقلاء في بعض مدركات العقل العملي لا يوجب تشكيكا في أصل إدراكات هذا العقل. ثم ان هنا شبهات وإشكالات أخرى للأشعريين تذكر في كتب الكلام لا مجال هنا لطرحها ومناقشتها فليراجع في مظانها.
بقيت في المقام نقطة هامة حاصلها : ان العقل العملي وحده لا يجدي في استكشاف الحكم الشرعي على أساسه ما لم نضم إليه مقدمة عقلية نظرية دائما هي قانون الملازمة بين ما حكم به العقل وما يحكم به الشرع.
وقد توهم بعضهم ان هذه الملازمة بديهية واضحة باعتبار ان الشارع سيد العقلاء فإذا حكم العقلاء بحكم بما هم عقلاء كان في طليعتهم وأول الحاكمين به ، ومن هنا ذكر ان التعبير بالتلازم مسامحة وانما الأصح التضمن لاندراج الشارع في العقلاء فيكون حكمه ضمن حكمهم.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم مرارا من ان الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع الأوسع من لوح الوجود وليسا امرين تشريعيين ، فحكم العقلاء في المقام يراد به إدراكهم لا تشريعهم أو بنائهم ، ثم لو فرض ذلك جريا مع مشرب